
ولد فى الأقصر مدينة الظل والضوء حيث تتجاور الأبدية مع النيل وحيث الموت حياة فى شكل آخر
أطل بهاء طاهر على العالم الأدبي بصوته الهادئ الذي يترك في النفس أثرًا لا يُمحى، كما تفعل الموسيقى الخافتة حين تملأ الغرفة بغيابها أكثر من حضورها. لم يكن صاخبًا في مواقفه ولا دراميًا في لغته، إلا أنّ أعماله كانت تحمل في عمقها توترًا خفيًا يشي بروح عاصفة. هو الكاتب الذي كتب من قلب الوطن، واستطاع أن يحوّل الهمس إلى حكاية.
وإذا كانت الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين قد شهدت تحولات كثيرة، بين التجريب والانفتاح على الميتاسرد وبين الواقعية الجديدة، فإن بهاء طاهر قد اختار طريقه الخاص: طريق يتكئ على البساطة دون أن يتنازل عن العمق، وعلى الصدق دون أن يفرّط في الجمال.
ولد في الأقصر، مدينة الضوء والظلّ، حيث تتجاور الأبدية مع النيل، وحيث الموت حياة واستمرار في شكل آخر. هناك، ربما، بدأ وعيه الأول بفكرة الزمن. منذ طفولته، كان يرى العالم بعيون مزدوجة: عين في الحاضر، وأخرى غارقة في الماضي. وحين كبر، حمل هذه الازدواجية إلى الكتابة، فصارت رواياته تمشي على الحدّ الفاصل بين الواقعي والأسطوري، بين الحكاية اليومية والرمز الكوني.

لم يكن بهاء طاهر كاتبًا يلاحق الأحداث، وإنما كاتبًا يلاحق المعنى. إنسان يرى في التفاصيل الصغيرة ما لا يراه الآخرون. كانت رواياته محاولات متكررة لفهم الإنسان المصري، لا بوصفه فردًا يعيش في بيئة محددة، وإنما بوصفه كائنًا يختزن التاريخ كله في ملامحه البسيطة. من هنا تنبع فرادته: إذ جعل من القرية المصرية، ومن الصحراء، ومن المدينة، رموزًا تتسع لتشمل التجربة الإنسانية كلها.
تتجلى في عالمه الروائي ثنائية الانتماء والاغتراب، الحلم والانكسار، الذاكرة والنسيان. وهو إذ يكتب، لا يقدم وصفًا مباشرًا لهذه الثنائيات، وإنما يدعها تتصارع داخل الشخصيات كما تتصارع الرياح داخل وادٍ مغلق. الشخصيات عنده لا تُروى عنها الحكاية فحسب، بل تروي نفسها وتفضح ضعفها وهشاشتها، كأنها تتحدث إلى القارئ من وراء زجاج الزمن. في رواياته، لا توجد نهاية نهائية، لأن كل حكاية تترك خلفها فراغًا يشبه الأثر في الرمل، أثرًا لا يمحوه الموج بسهولة.
اعترافات
لم يكن بهاء طاهر مشغولًا ببناء عالم متكامل على الطريقة الكلاسيكية، حيث الأحداث تتتابع وفق منطق سببي صارم، وإنما كان مشغولًا بتصوير الانفعال الإنساني في لحظة التمزق أو الوعي. كل رواية عنده هي نوع من الاعتراف الطويل. في واحة الغروب، تتحول الصحراء إلى اختبار للروح، وفي خالتي صفية والدير يتحول الصراع إلى أسطورة عن الغفران، وفي شرق النخيل يصبح السفر نوعًا من العودة المستحيلة.
إن عالمه الروائي لا يمكن فهمه إلا باعتباره استمرارًا لسؤال أخلاقي يلاحق الكاتب منذ بداياته: هل يستطيع الإنسان أن يظل طيبًا في عالم قاسٍ؟ هذا السؤال، الذي يبدو بسيطًا في ظاهره، هو ما يشغل كل شخصياته. الجنود، الرهبان، النساء الصامتات، الرحّالة، المنفيون، جميعهم يبحثون عن معنى للخير وسط العنف، وعن الحب وسط الخسارة. وكأن الرواية عنده ليست سوى محاولة لكتابة سيرة الإنسانية في لحظة ضعفها الأعظم.
حين نقرأ أعمال بهاء طاهر، نكتشف أن الزمن عنده ليس خطيًا، بل دائريّ، يعود إلى النقطة نفسها في نهاية كل رواية. يكتب عن الحاضر كأنه الماضي، وعن الماضي كأنه الحاضر، لأن ما يتغيّر هو السطح فقط، أما جوهر الإنسان فواحد. وهو إذ يستعيد التاريخ، لا يكتبه كحكاية منتهية، ولكن كجسد يتنفس في الواقع المعاصر. لذلك نجد في كل رواياته مزيجًا دقيقًا من الواقعي والرمزي، من الحسي والميتافيزيقي، من اليومي والأسطوري.
يمتلك بهاء طاهر قدرة نادرة على تحويل التجربة الفردية إلى رؤية كونية. إنه ابن المكان المصري، لكنه في الوقت ذاته كاتب يتحدث إلى الإنسان في أي مكان. فحين يكتب عن الفلاح الذي يقتل أو الراهب الذي يغفر أو الضابط الذي يعاقَب، فإنه يكتب عن صراع الضعف والقوة في داخلنا جميعًا. في هذا المعنى، لا يمكن حصر عالمه في الحدود الجغرافية أو التاريخية، لأنه عالم يتجاوزها نحو جوهر الوجود الإنساني ذاته.
ومع أن تجربته لم تتكئ على التلميع الإعلامي أو الحضور المتكرر، فقد ظل أثره في الوجدان الأدبي عميقًا. إن من يقرأه يشعر أن الرواية العربية بلغت معه مرحلة النضج الهادئ، حيث لا حاجة إلى الصراخ كي يُسمع الصوت، ولا حاجة إلى الزخرفة كي تُرى الحقيقة.
الخطابات
تبدأ الحكاية في رواياته غالبًا من تفصيلة صغيرة: لقاء عابر، جملة منسية، حدث يبدو بسيطًا، غير أن هذه البذرة السردية تتسع شيئًا فشيئًا لتحتضن العالم كله. لا يبحث الكاتب عن الإثارة، بقدر ما يبحث عن المعنى الكامن في البساطة. فالحكاية عنده ليست نتاج خيال متكلف، وإنما استجابة لصوت خفي يسمع الوجع الإنساني كما يسمع الطبيب نبض المريض. ولهذا تأتي الحكايات هادئة في ظاهرها، لكنها تتغلغل في أعماق القارئ لتترك فيه أثرًا عميقا.
في رواياته الأولى، تظهر الحكاية في صيغة حكايات متداخلة. هذا التكرار المقصود يمنح السرد بعدًا تأمليًا، ويجعل الحكاية أقرب إلى دورة حياة منها إلى خط مستقيم. الراوي يحكي، ثم يتراجع، ثم يعيد النظر في ما حكاه، كأن السرد ذاته عملية بحث، لا امتلاك للمعرفة. وبهذا يتحول الفعل السردي إلى صورة من صور التفكير الوجودي، لأن الراوي لا يكتفي بسرد الحدث، لكنه يضع نفسه في موضع التساؤل.
ورغم أن الحكايات عند بهاء طاهر تنتمي في ظاهرها إلى الواقعية، فإنها لا تُقدَّم بوصفها توثيقًا للحياة، وإنما تأملًا فيها. فالحكاية الواقعية عنده تقوم على إعادة تشكيله وفق منطق الذاكرة. الذاكرة لا تروي بدقة، بل تروي بما يتركه الحدث في النفس من أثر. لذلك، يصبح السرد محاولة لترميم ما انكسر في الوعي. فكل حكاية تحمل في طيّاتها رغبة في التصالح، لا مع العالم فقط، ولكن مع الذات التي شهدت وتعبت.
في هذا السياق، يمكن القول إن الحكاية عنده تحمل بعدًا فلسفيًا خفيًا؛ إذ تنبع من شعور الإنسان بالزوال، ومن حاجته إلى تأكيد وجوده عبر الكلمة. فالكائن الذي يحكي يعلن أنه عاش، وأن لحياته معنى يستحق أن يُقال. الحكاية تمنح الوجود شكله اللفظي، وتمنح التجربة ملمسها الإنساني. لذلك، فإن أبطال بهاء طاهر حين يروون قصصهم لا يسعون إلى البطولة، بقدر سعيهم إلى الشهادة، لأن الشهادة هي البقاء الوحيد الممكن في عالم محكوم بالعبور.
ومن اللافت في عالمه السردي أن الحكاية تنبع من تعدد الأصوات والرؤى. الراوي لا يحتكر الحقيقة، لكنه يشاركها مع الآخرين، لأن الحقيقة عنده ليست يقينًا، إنها وجهًا من وجوه التجربة. كل شخصية تملك زاويتها الخاصة في النظر إلى الحدث، وهذا التعدد يمنح البناء الروائي، غناه ودقّته. إن تعدد الرواة ليس تقنية شكلية، وإنما تعبير عن إيمانه بأن الإنسان لا يملك العالم وحده، وأن فهم الواقع يحتاج إلى تنوّع الرؤى لا إلى تسلّط الصوت الواحد.
تتشابك الحكايات في أعماله كما تتشابك طرق الذاكرة، فينقلك السرد من الخاص إلى العام، ومن الفردي إلى الجمعي، في تدرّج طبيعي يجعل كل مصير فردي صورة مصغّرة لمصير الجماعة. وهنا تتجلى عبقريته في تحويل التجربة الشخصية إلى مرآة للوجدان الجمعي المصري، بحيث تبدو الحكاية الصغيرة وكأنها تلخّص تاريخًا كاملًا من الأحلام والانكسارات.
المكان في عالم بهاء طاهر ليس مساحة صامتة تجري فيها الأحداث، ولا خلفية محايدة تتحرك فوقها الشخصيات، وإنما كيان نابض بالحياة، يشارك في السرد كما يشارك القلب في إيقاع الجسد. كل موضع في رواياته يحمل ذاكرة، وكل ذاكرة تملك صوتًا خفيًا. فالمكان عنده ليس مجرّد جغرافيا، هو كائن من لحم الروح، يسكن أبطاله كما يسكنونه، ويتحوّل معهم في لحظات الوعي والضياع.
تبدأ علاقة بهاء طاهر بالمكان من طفولته في الأقصر، تلك المدينة التي يتعانق فيها الموت بالحياة، ويطل فيها الماضي بعيونه الواسعة على الحاضر الضيق. الأقصر ليست مجرد مدينة قديمة بالنسبة له، بل نقطة البدء في التكوين الجمالي والروحي. هناك تعلّم أن المكان لا يُقرأ بالعين وحدها، وإنما بالذاكرة. فكل حجر يحمل أثرًا، وكل ظلّ يخفي حكاية. من هذا الإدراك المبكر خرجت رؤيته التي جعلت المكان في رواياته يحمل بعدًا رمزيًا يتجاوز تحديداته الواقعية، ليصبح ذاكرة تتكلم وتفكر وتحنّ.
واحة الغروب
في "واحة الغروب"، تتحول الصحراء إلى كائن متأمل، يبدو ساكنًا في الظاهر، غير أنه يعيش في صمت يشبه تفكير الإنسان حين يواجه مصيره. الصحراء هنا ليست فضاءً للضياع فقط، وإنما معادل وجودي للبحث عن المعنى. كل حبة رمل تذكّر بالبداية والنهاية، وكل وهج شمس يذكّر بالامتحان الذي يخوضه الإنسان في مواجهة ذاته. في هذا العمل، يذوب الحد الفاصل بين الجغرافيا والوجدان، فتصبح الصحراء مرآة للشخصية المصرية وهي تحاول أن تفهم نفسها بعد زمن طويل من الخيبات.
أما في "خالتي صفية والدير"، فيأخذ المكان شكل القرية المصرية التي لا تكف عن تكرار مأساتها القديمة. القرية عنده ليست مجرد موضع للحكاية، إنها بنية ذهنية وروحية تتقاطع فيها مفاهيم الشرف، الثأر، المقدّس، والمغفرة. الدير في الرواية ليس بناءً حجريًا على أطراف القرية، وإنما رمزًا للعزلة الرحيمة، للمكان الذي يطهّر الدم من الخطيئة، ويعيد للعالم توازنه بعد العنف. في هذا التفاعل بين القرية والدير، تتجسد الثنائية التي تشغل الكاتب: الصراع بين الغريزة والرحمة، بين العادة والصفاء الروحي.
المكان في روايات بهاء طاهر دائم الحركة، يتغيّر بتغيّر الوعي. القاهرة التي تظهر في بعض نصوصه، ليست العاصمة الضاجة فقط، وإنما متاهة روحية تتقاطع فيها الأصوات والأزمنة. الشوارع الضيقة، المقاهي القديمة، الأحياء المهجورة، كلها تحضر بوصفها شواهد على زمن يتآكل. المدينة عنده كائن يتنفس ببطء، يشيخ مع أبطاله ويخبو بريقه كما تخبو أحلامهم. فالمكان هنا ليس مجرد وصف بصري، بقدر ما هو ذاكرة جماعية تتناثر بين الحجر والبشر، بين ما يُبنى وما يُهدم.
المكان
يمتلك بهاء طاهر قدرة نادرة على جعل المكان جزءًا من الحكاية لا زينتها. إنه لا يصف المكان كي يُرضي العين، وإنما كي يوقظ الحواس الأخرى: السمع، الشم، اللمس، والحنين. في نصوصه، تمتلك الصحراء رائحة الملح والتراب، وتتناثر في هواء القرية أصوات المواشي والصلوات، بينما تلوح القاهرة من بعيد كمدينة تبحث عن خلاصها في زحامها. هذه التفاصيل ليست مجرد تلوين فني، وإنما إشارات إلى عمق العلاقة بين الإنسان ومحيطه.
في كثير من الأحيان، يبدو المكان عنده شاهدًا على جريمة لا تنتهي، أو على حبّ لم يكتمل. فالأماكن التي يختارها تحمل دائمًا أثر فقدان ما، كأنها تحفظ داخلها ذاكرة الخسارة الأولى. إن المكان في عالمه يحتفظ بملامح من غابوا، بضحكاتهم وأصواتهم وأخطائهم، وكأن الحجارة تعرف أكثر مما يقول البشر. لهذا يبدو المكان في رواياته أقرب إلى الذاكرة الجمعية منه إلى المشهد الطبيعي، لأنه يذكّر الإنسان بما كان، ويذكّره أيضًا بما لم يعد ممكنًا.
ولعل ما يميّز بهاء طاهر عن غيره من الكتّاب أنه يتعامل مع المكان بصفته ذاكرة جماعية أكثر منها مسرحًا فرديًا. المكان لا يخصّ بطلًا واحدًا، بل يشترك فيه الجميع. في القرية، الجميع يعرف الجميع، وفي الصحراء، الجميع غريب في وجه الآخر. حتى الأمكنة المغلقة، كالغرفة أو الدير، تحمل في داخلها أثر الخارج، لأن الجدران عنده تحفظ ما يجري خارجها في شكل من أشكال الصدى. هذا الإدراك يجعل المكان في رواياته حاضنًا لتجربة الإنسان في أبعادها المتعددة: التاريخية، الاجتماعية، والروحية.
يقف الإنسان في عالم بهاء طاهر دائمًا عند مفترق الطرق، كأنه كائن وُلد في لحظة التردد بين أن يكون حرًّا أو أن يكون قدرًا. في كل رواية، نجد هذا الكائن المسكون بالأسئلة يعيش بين قوتين متصارعتين: التاريخ الذي يفرض عليه مساره من الخارج، والقدر الذي يلاحقه من الداخل. ومن هذا الصراع ينشأ توتر العالم في نصوصه، حيث تتحوّل الحكاية إلى مختبر للوعي الإنساني، ويغدو كل حدث سؤالًا أخلاقيًا عن الحرية، والمعنى، والمصير.
الإنسان
الإنسان في روايات بهاء طاهر ليس بطلًا كلاسيكيًا يواجه العالم بشجاعة مطلقة، ولا ضحية كاملة تُساق بلا إرادة، إنه كائن هشّ يحاول أن يفهم ما يجري له وسط عاصفة من القوى التي تتجاوزه. إنه يعيش في التاريخ دون أن يملك زمامه، ويؤمن بالقدر دون أن يقدر على التسليم الكامل به. هذه الازدواجية هي جوهر التجربة الإنسانية عند الكاتب، وهي ما تمنح شخصياته عمقها النفسي والوجودي.
لا يظهر الإنسان عند بهاء طاهر محاصرًا بالتاريخ وحده، وإنما أيضًا بموروثه الداخلي، بالخوف والرغبة والشك. إنه يعيش في دائرة من القوى التي تسيّره، غير أنه لا يتوقف عن السؤال. هذه القدرة على التساؤل هي ما تمنحه إنسانيته. فالشخصيات لا تتحرك وفق منطق الرواية التقليدية، ولكن وفق نبض داخلي يتأرجح بين الإيمان والخيبة. وحين تسقط، تسقط بكرامة، لأن سقوطها اعتراف بالضعف الإنساني، لا استسلام للعدم.
التاريخ في نصوصه طاقة حاضرة تفرض نفسها على الحاضر. إنه القوة الخفية التي تلوّن كل قرار، وتجعل الإنسان يعيش في ظلال ما حدث أكثر مما يعيش في واقعه الفعلي. ومع ذلك، لا يُقدَّم هذا التاريخ بصورة جامدة أو مدرسية، ولكن في هيئة مصائر فردية تروي الخسارة الكبرى للإنسان الذي حلم بالتغيير ولم يجد إلا العزلة. فالبطل في نهاية الأمر ليس ضحية السياسة أو المجتمع فقط، بل ضحية وهمه الخاص بأنه قادر على السيطرة على مجرى الأحداث.
البطل
من هنا تبدو الحرية في عالم بهاء طاهر حلمًا ملتبسًا، ليست مطلقة ولا معدومة، وإنما مشروطة بقدرة الإنسان على مواجهة وعيه. فالحرية ليست ما يمنحه المجتمع، وإنما ما يكتشفه الفرد حين يواجه قدره دون خوف. محمود عبد الظاهر، صفية، الراهب، الفلاح، الجندي، جميعهم يواجهون أنفسهم في لحظة الحقيقة، ويكتشفون أن ما ظنوه قدَرًا هو في كثير من الأحيان اختيار متأخر. هذه اللحظة، التي تلتقي فيها الرغبة بالاعتراف، هي ذروة التراجيديا في عالم بهاء طاهر، حيث الإنسان يكتشف أنه مسئول عن ألمه بقدر ما هو ضحيته.
يحمل الكاتب حسًا وجوديًا خافتًا يقترب من الفلسفة، دون أن يتورط في تجريدها. فهو لا يطرح أسئلته عبر الأفكار المجردة، بل عبر الموقف الإنساني البسيط: امرأة تنتظر، رجل يتأمل الخراب، شخص يروي حكايته بعد فوات الأوان. ومن هذه التفاصيل الصغيرة تتشكل المأساة الكبرى، لأن التاريخ الحقيقي في رواياته ليس ما كُتب في الكتب، بل ما عاشه الناس في صمتهم، في خوفهم، وفي محاولتهم الفاشلة لأن يبدؤوا من جديد.
إن الإنسان الممزق بين التاريخ والقدر هو الإنسان الذي يحمل في داخله جرح الأزمنة كلها. لا يعرف إلى أين يمضي، ولا يستطيع أن يعود. يعيش محاصرًا بين صوتين: صوت الماضي الذي يطالب بالوفاء، وصوت الذات التي تطلب الغفران. في هذا المدى القاسي، تبرز رحمة الكاتب، فهو لا يدين أحدًا، لكنه ينصت إلى الجميع. كل شخصية عنده تستحق أن تُفهم، لأن كل إنسان في نظره ضحية معركة لا يختارها.
ومع أن أبطاله يعيشون الهزيمة، فإنهم لا يغرقون فيها. هناك دائمًا في أعماقهم بقايا حلم، وومضة أمل، كأن الهزيمة ليست النهاية بل بابًا آخر لإعادة النظر. هذا الإصرار على بقاء الروح، رغم التاريخ والقدر، هو ما يمنح روايات بهاء طاهر ذلك النور الإنساني الذي لا يخبو. إن شخصياته تسير في عتمة الوعي، لكنها تحمل في قلبها شعلة صغيرة تكفي لتقول إنها ما زالت حية.
وهكذا، يتحوّل الصراع بين التاريخ والقدر في عالمه إلى مرآة للعالم ذاته. التاريخ يفرض قوانينه، والقدر يسخر من خطط البشر، غير أن الإنسان يظلّ يسعى، يحلم، ويحبّ، حتى وهو يعلم أن النهاية مكتوبة سلفًا. تلك هي البطولة الحقيقية في أدبه: أن يواصل الإنسان السير رغم معرفته بأنه لن يصل، وأن يجد في هذا السعي معنى الحياة نفسها.



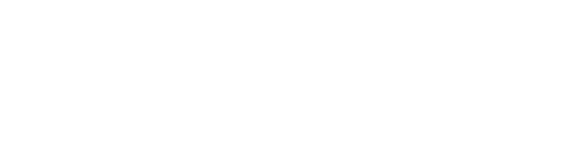








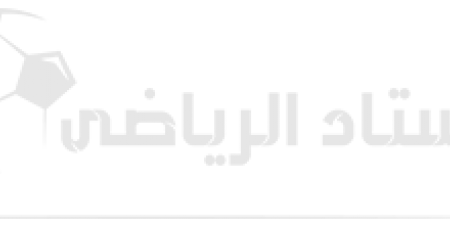

0 تعليق