ليست كل الأفلام تُروى؛ بعضها يُستعاد كذاكرة بصرية متجسدة.
ينتمي الفيلم الجزائري «الساقية» (2024) للمخرج نوفل كلاش إلى ذلك النمط من الأعمال التي تتعامل مع التاريخ كمساحة حية للتأمل في كيفية سرده واستعادته بصريًا.
يقدم الفيلم تجربة رائدة في السينما الجزائرية من خلال مقاربة تحريكية ثلاثية الأبعاد تعيد بناء مجزرة ساقية سيدي يوسف (8 فيفري 1958) داخل رؤية فنية تتجاوز التوثيق المباشر نحو بناء تجربة حسية تستثير الوجدان قبل أن تستدعي الفهم.
بهذه المقاربة، يفتح الفيلم نقاشًا جماليًا حول قدرة الأنيميشن على استعادة الأثر الإنساني لما فُقد في الواقع، ويؤسس لسردية جديدة لذاكرة الثورة الجزائرية عبر أدوات السينما الرقمية التي تمزج بين التقنية والانفعال، وبين التاريخ كحدث والتاريخ كإحساس.
حين تُروى الذاكرة بعيون الطفولة
يرتكز فيلم «الساقية» على حبكة بسيطة في ظاهرها، عميقة في بنيتها الدلالية، عائلة مجاهد تضطر إلى اللجوء من «سوق أهراس» إلى «ساقية سيدي يوسف» على الحدود التونسية، حيث تنشأ صداقة بين الطفلين عمار (الجزائري) ومنصف (التونسي). غير أن هذه البراءة الطفولية لا تلبث أن تُقابل بوحشية القصف الاستعماري الذي يحول المكان إلى رماد، في مشهد يختصر المأساة الإنسانية للحرب.
تقوم هذه المعادلة السردية على ثنائية الذاكرة والبراءة، وهي ثنائية صاغها كاتب السيناريو والمنتج المنفذ «الطيب توهامي» بوعي درامي يوازن بين الوثائقي والتخييل، بين الذاكرة الجماعية والعاطفة الفردية. أما المخرج نوفل كلاش فاستثمر هذا البناء الذكي ليركز على التفاصيل الإنسانية الصغيرة –نظرة، حركة، أو لحظة صمت– باعتبارها حوامل للمعنى التاريخي أكثر من كونها عناصر للحبكة التقليدية.
تتبلور اللغة البصرية للفيلم بوصفها محور التجربة الجمالية بأكملها، إذ يتجاوز اختيار تقنية الأنيميشن ثلاثي الأبعاد حدود التجريب التقني، ليغدو أداة رمزية في حد ذاته. فالفيلم يوظف هذا الوسيط الرقمي لإعادة تشكيل الذاكرة خارج قيود التوثيق الفوتوجرافي، ما يتيح إعادة تخييل الكارثة بدرجة من التحكم الجمالي والترميز التعبيري.
توظف الكاميرا الافتراضية في حركات دائرية وانسيابية تحيط بالشخصيات، بما يحول المشهد إلى فضاء دائري يعيد تمثيل دورة الذاكرة والتاريخ؛ فالحركة تُقرأ هنا باعتبارها استعارة للحركة المستمرة للزمن داخل الوعي الجمعي.
وإذا كانت الصورة في «الساقية» تُعيد بناء الذاكرة عبر الضوء واللون، فإن الصوت يفعل ذلك عبر النغمة والهمس. تشكل موسيقى «أحمد فيرود» في الفيلم بعدًا حسيا مكملًا للبنية البصرية، فهي تأتي في موقع امتداد وجداني للصورة. تعتمد الموسيقى على تنويعات لحنية هادئة تتدرج من الشجن إلى الصمت، لتصبح أحيانًا أقرب إلى ذاكرة صوتية تتسرب إلى المشاهد أكثر مما تُسمع مباشرة. هذا الانضباط في التوظيف الموسيقي يمنح الإيقاع العام للفيلم طابعًا تأمليًا.
على مستوى الأداء الصوتي، يبرز الفنان «عبد الباسط بن خليفة» في دور الجد بصوت عميق متعب، يحمل في طبقاته حنينًا ووقارًا معًا. أداؤه يضفي على الشخصية ثقلًا وجوديًا، إذ يجسد فكرة «الذاكرة الناطقة» التي تنقل الحكاية عبر نبرات تفيض بالحكمة والانكسار. أما صوتا يسرى منار (عمار) وإيناس منار (منصف) فيضيفان طبقة نقية من البراءة تقابل خشونة العالم الخارجي، ليشكل التباين بين الأصوات الثلاثة بناء صوتيًا يوازي البناء البصري في معناه.
تحمل الأصوات ملمحًا محليًا يذكر ببيئة سوق «أهراس»، ما يمنح المشهد السمعي خصوصيته المحلية ويُرسخ الجغرافيا في أذن المتلقي كما تُرسخ الصورة المكان في ذاكرته البصرية.
بهذا الدمج بين الموسيقى والصوت، يتجاوز الفيلم مستوى التوثيق إلى تشكيل ذاكرة سمعية–بصرية متكاملة، تُعيد إحياء الحدث الماضي، كصدى مستمر في الحاضر.
في «الساقية» تتكثف التقنية داخل النسيج السردي؛ إذ تتحول أدوات التحريك الثلاثي الأبعاد إلى بنية أسلوبية تعبر عن فكرة الفيلم ذاتها، وهي استعادة الماضي عبر وسيط رقمي قادر على محاكاة الذاكرة. يعمل الفريق التقني الجزائري، الذي يضم أكثر من ستة عشر مختصًا في مجالات التحريك والمؤثرات البصرية، على بناء فضاء بصري يمزج بين الواقعي والتخييلي، مستعينًا بدعم مؤسساتي من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة الثقافة والفنون.
انطلقت مراحل التنفيذ سنة 2023 من مدينة الكاف التونسية، في اختيار يرمز إلى التماس بين الجغرافيا التاريخية التي شهدت المجزرة والفضاء الفني الذي يعيد سردها. هذا التلاقي بين المكان الحقيقي والعالم الرقمي يمنح الصورة عمقًا مزدوجًا، فهي تُحاكي التاريخ وتعيد تخييله في الوقت نفسه. ومع أن معظم الشخصيات في الفيلم خيالية المنشأ، إلا أنها تتحرك ضمن إطار واقعي موثق، ما يضع العمل في منطقة وسطى بين «الأنيميشن الواقعي» و«الخيال التاريخي التوثيقي».
هكذا تُستخدم التقنية كوسيط معرفي يُعيد الحياة لما غاب عن الصورة الأرشيفية، ويجعل الذاكرة حدثًا متجددًا في كل لقطة.
يستثمر «الساقية» بنيته الحكائية لتفعيل بعد فكري وإنساني يتجاوز التمثيل السردي البسيط. فمن خلال الصداقة البريئة التي تجمع بين الطفلين عمار (الجزائري) ومنصف (التونسي)، يستعيد الفيلم فكرة التضامن المغاربي في أحد أنقى تجلياتها، حين لا تتجسد الوحدة في الشعارات وإنما في عاطفة الطفولة ذاتها. بهذه العلاقة، يتحول الحدث المحلي إلى رمز إنساني كوني يعيد تأكيد قدرة الفن على ترميم ما تمزقه السياسة والتاريخ.
تغدو الساقية في هذا السياق أكثر من موقع جغرافي؛ إنها علامة رمزية للجرح المشترك بين الشعبين، واستعارة بصرية لامتداد الدم في الماء كما يوحي العنوان نفسه. فالماء هنا حامل لذاكرة الألم والتضامن في آن واحد.
لا ينزلق الفيلم إلى خطاب سياسي مباشر، فقد اختار طريق أنسنة التاريخ من خلال بناء بصري وشاعري يتجاوز التوثيق نحو التأمل. وبهذا يُقدم «الساقية» نموذجًا لكيف يمكن للسينما، حتى في أكثر وسائطها رقميةً، أن تُعيد للحكاية الإنسانية مركزها في مواجهة النسيان.
في الحقيقة، لا ينتهي «الساقية»عند حدود حكايته؛ إنه عمل يبدأ من الحكاية لينفتح على أسئلة أوسع حول علاقة السينما بالذاكرة وبالجيل الذي يخاطبه.
يشكل «الساقية» محطة مهمة في مسار السينما الجزائرية، والعربية أيضًا. إذ ينجح في الجمع بين الأنيميشن بوصفه فنا معاصرًا والذاكرة الثورية بوصفها مادة رمزية وإنسانية، ليقترح ما يمكن تسميته بـ الأنيميشن الوطني؛ أي توظيف الوسائط الحديثة في إعادة إنتاج الوعي الجمعي.
يتعامل الفيلم مع القصف الاستعماري كصدمة وجودية تنعكس في وجوه الأطفال وأصواتهم، فتتحول المأساة الجماعية إلى مرثية للطفولة المفقودة وإلى تأمل في هشاشة الحياة زمن الحرب. بذلك، يُعيد العمل رسم لحظة لم تلتقطها الكاميرات، لكن الفن –بخياله البصري وذكائه التكنولوجي– أعاد منحها حياة ثانية داخل الذاكرة الثقافية.
في نهاية التجربة، يقدم «الساقية» درسًا في إمكان الجمع بين الأصالة والابتكار، بين التاريخ والوسيط الرقمي، مؤكدًا أن السينما، حين تجرؤ على إعادة صياغتها، تستطيع أن تجعل التاريخ يخاطب أبناءه بأدوات عصرهم، لتجعل الذاكرة الوطنية فعلًا فنيًا حيًا يروي الحقيقة بروح معاصرة.
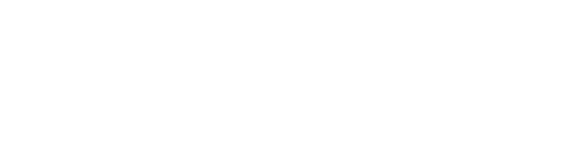










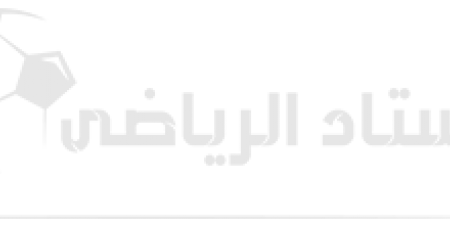

0 تعليق